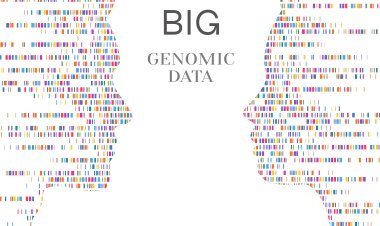التفكير على مستوى النظام: الحل الجذري لفهم السياسات التي تفشل رغم نواياها النبيلة
كيف يغيّر التفكير على مستوى النظام فهمنا للسياسات العامة، من خلال تفكيك قرارات التوظيف القسري، ونقل الصناعات من أمريكا إلى الصين، مع استعراض للأثر البنيوي والزمني والثقافي، عبر عدسة التفكير المنظومي الست. قراءة ضرورية لكل باحث في السياسات، والإدارة، وبناء الأنظمة المستدامة.

التفكير على مستوى النظام: عدسةٌ لفهم ما وراء الظواهر
حين نتحدث عن "التفكير على مستوى النظام" فنحن لا نشير إلى تقنية تحليلية باردة أو إلى مصطلح يُستخدم في أدبيات الإدارة الحديثة فحسب، بل إلى انتقال نوعي في مستوى الوعي، يسمح للعقل أن يرى ما وراء الأجزاء المتفرقة، ويتجاوز حدود السببية الخطّية البسيطة ليبلغ نضجًا إدراكيًا يرى الكلّ، لا من خلال جمع الأجزاء، بل من خلال فهم العلاقات والتفاعلات والتحولات التي تشكّل كيانًا حيًّا متغيرًا، يُعرف بالنظام.
في هذا النمط من التفكير، لا تكفي ملاحظة الظواهر، بل يستلزم الأمر الغوص في ديناميكياتها، والانتباه إلى حلقات التأثير المتبادل، وإلى الزمن لا بوصفه لحظة، بل كتسلسل وتطور ونمو أو تدهور. فالتفكير المنظومي لا يركن إلى التفسير الفوري، ولا ينخدع بالمؤشرات الظاهرة، بل ينشد نمطًا أعمق من الفهم يرتبط ببنية النظام لا سلوكه السطحي.
تتجلى مرتكزات هذا النوع من التفكير في ستة محاور مترابطة:
-
تكامل الكلّ وتجاوز الجزء
فكل نظام – مهما صغر أو تعقّد – يتكوّن من مكونات ترتبط فيما بينها بعلاقات دائمة التغير، لا يمكن فهم سلوك أي منها خارج إطار هذا الارتباط. إن معرفة أحد الأعضاء دون فهم الشبكة التي ينتمي إليها تشبه فهم كلمة خارج سياقها؛ قد نعرف تعريفها، لكننا لا ندرك وظيفتها أو مغزاها الحقيقي. -
التغذية الراجعة: آلية التوازن أو الانفلات
الأنظمة تتحدث مع ذاتها من خلال ما يُعرف بالتغذية الراجعة، وهي دوائر من التأثير المتبادل، إما تُعزّز السلوك (feedback معزز)، أو تضبطه (feedback موازن). هذه الدوائر هي نبض النظام، وهي التي تحدد مسارات تطوره أو تدهوره، ومآلاته طويلة الأمد. -
الزمن: من اللحظة إلى الاتجاه
ما يميّز المفكر المنظومي هو إدراكه أن "الآن" ليست كل شيء، بل هي لحظة في مسار أطول. ولذلك لا يُغريه المؤشر اللحظي، بل يسعى لفهم الاتجاه العام، ومن ثمّ التنبؤ بالمآلات لا الانبهار بالنتائج المؤقتة. -
التأثيرات غير المباشرة والفجوات الزمنية
ليست كل نتائج النظام فورية. وقد يقع الخطأ الفادح حين يتم تقييم قرارٍ ما بناءً على أثره اللحظي دون الانتظار لرؤية نتائجه المؤجلة. فبعض الأفعال تبذر بذورًا لا تنبت إلا بعد سنوات، وقد يبدو القرار حكيمًا اليوم ثم يُكشف ضعفه بعد حين. -
الحدود والسياق: وهم الثبات
كل نظام يعمل ضمن بيئة، لكن ما نحدده كـ "حدود" لهذا النظام ليس دائمًا ماديًا أو واضحًا. فقد تكون الحدود إدراكية أو تحليلية، يضعها الباحث بناءً على افتراضاته. ولذلك، فإن نظرتنا للنظام قد تحدد ما نراه فيه، وما نغفل عنه. -
النموذج الذهني: عدسة الرؤية لا مرآتها
لا نرى النظام كما هو، بل كما نتصوره. ونماذجنا الذهنية – رغم ما تمنحنا من فهم – هي في ذاتها جزء من النظام لأنها تؤثر في قراراتنا، واستجاباتنا، وتقييمنا للأثر. وقد تكون هذه النماذج مشوشة أو مبسطة أو مشوّهة، فتقودنا إلى أحكام خاطئة مهما بلغت دقة بياناتنا.
وباختصار، التفكير المنظومي ليس مجرّد مهارة تحليلية، بل هو انضباط ذهني ونضج معرفي، لا يرى العالم بوصفه مجموعة مشكلات مستقلة، بل كسلسلة معقدة من الترابطات والتفاعلات والمآلات. وهو بذلك، لا يسعى للحلول السريعة، بل لصياغة سياقات تنتج الحلول من تلقاء ذاتها، كما تنبت الشجرة في بيئة خصبة دون إكراه.
الأثر التنظيمي بين وهم النتائج وسلوك الأنظمة
في عالم الإدارة والسياسات العامة، كثيرًا ما يُختزل التقييم إلى سلسلة سببية مغرية ببساطتها: قرار → نتيجة. هذه النظرة، رغم جاذبيتها الظاهرية، تخون طبيعة الواقع المؤسسي المركّب الذي لا يستجيب – كما تتوهم النظريات الخطّية – بآلية ميكانيكية، بل يتفاعل، يتشكل، ويعيد إنتاج نفسه وفق منطق داخلي يصعب الإمساك به عبر الملاحظة السطحية وحدها.
هنا يبرز "التفكير على مستوى النظام" ليس كأداة تحليل إضافية، بل كعدسة ضرورية، تتيح لنا الانتقال من قياس الأثر إلى فهم النظام.
أولًا: الأنظمة التنظيمية ليست جمادات.. بل كائنات ديناميكية
المؤسسة ليست هيكلًا إداريًا، بل نظام معقد من الموارد، والسلوكيات، والثقافة، والضغوط، والمحفزات، والتاريخ. وعندما يُلقى في هذا النظام قرار تنظيمي جديد، فإن الاستجابة لا تكون تلقائية، بل تتفاعل المكونات فيما بينها، وتُعيد تشكيل النظام وفق آليات لا يُدركها من ينظر فقط إلى المؤشرات الرقمية.
فمثلًا، حين تُقرر جهة تنظيمية خفض عدد الموظفين لتقليل النفقات، قد تتحقق الكفاءة ظاهريًا، لكن ما لا يُقاس هو الانهيار المعنوي في الفريق، أو التوتر الذي يفرض تعيين مستشارين خارجيين لاحقًا بتكلفة أعلى، أو حتى تراجع جودة الخدمة بطريقة تُفقد المؤسسة مكانتها تدريجيًا.
النتيجة هنا ليست مجرد تقليص رقمي، بل تغير في بنية النظام نفسها، لا يدركه إلا من ينظر إلى النظام ككائن يتفاعل لا كمجموعة أوامر تُنفذ.
ثانيًا: ما بين "الأثر المباشر" و"الأثر البنيوي"
المفكر المنظومي يُدرك أن ما يُقاس ليس دائمًا ما يُهم. فقد تُسجل تقارير الأداء تراجعًا في الشكاوى بنسبة 10٪، لكن السبب لا يكون تحسين الخدمة، بل فقدان المستفيدين للثقة في جدوى الشكوى. وهذا ما نسميه بالأثر البنيوي أو "المنظومي" – الأثر الذي لا يظهر في البيانات المباشرة، لكنه يُعدّل سلوك النظام من داخله.
والفرق بين الأثر اللحظي والأثر المنظومي هو الفرق بين سلوك مرصود وسلوك مكبوت، بين نتيجة ظاهرية وتحول ثقافي خفي، بين استجابة مفروضة وتحوّل طوعي.
ثالثًا: الخرائط الديناميكية.. رؤية ما لا يُرى
التفكير المنظومي يُوفّر أدوات تتجاوز الملاحظة إلى النمذجة، من خلال خرائط التدفق والتغذية الراجعة، التي تكشف البُنى غير المرئية خلف الظواهر:
-
كيف تؤدي سياسات الأداء إلى رفع معدل دوران الموظفين؟
-
لماذا يتحول الامتثال إلى تحايل حين يغيب المعنى؟
-
ما علاقة الضغط التنظيمي بتراجع التعاون الداخلي؟
هذه الأسئلة لا تُطرح عادة في تقييم الأثر، لأنها لا تُقاس بسهولة، لكنها تصنع الفارق بين قرار يعيش أسبوعًا وقرار يُعيد تشكيل المؤسسة.
رابعًا: منطق الفشل.. حين يُغفل النظام وتُخدع المؤشرات
تأمل عددًا لا يُحصى من الإصلاحات الإدارية التي انتهت إلى بيروقراطية أكثر تعقيدًا، أو برامج تحفيزية أنجبت بيئات تنافسية سامة، أو قرارات "تحسين كفاءة" أفقدت الفرق الثقة والإبداع.
ما يجمع هذه الإخفاقات ليس ضعف النية، بل غياب الفهم المنظومي. لأن السياسات صُممت لمشكلة منعزلة، لا لبنية تنتج تلك المشكلة. فكما لا يُجدي علاج حمى ناتجة عن التهاب داخلي بإعطاء خافض حرارة فقط، لا تُجدي السياسات التي تُخاطب العرض وتتجاهل المصدر.
خامسًا: من "التحليل" إلى "الوعي بالنظام"
في الختام، التفكير على مستوى النظام لا يقدّم فقط أدوات لفهم ما يحدث، بل يعيد تعريف سؤال الأثر من أساسه. لا يُسأل: "ماذا حدث؟" بل "لماذا حدث؟ وكيف سيتشكل النظام بعده؟ وما هي الحلقات التي لم نرها وستُعيد تشكيل الواقع لاحقًا؟".
فإذا لم نفهم أن كل قرار يُطلق سلسلة من التفاعلات، بعضها مرئي، وأكثرها خفي، فإننا لا نقيس أثر القرار، بل نرصد ظله.
ولذلك، فإن التفكير المنظومي ليس ترفًا معرفيًا، بل ضرورة وجودية لأي مؤسسة تسعى إلى فعالية مستدامة، لا نجاحات مؤقتة. إنه الانتقال من إدارة الإجراءات إلى هندسة البُنى، من ردود الفعل إلى استبصار النظام.
دراسة حالة: عندما تُرحَّل الوظائف وتُرحَّل معها الهوية: قراءة منظومية لقرار نقل المهارات من أمريكا إلى الصين
إن من أبرز الأمثلة العالمية التي تُجسّد الحاجة للتفكير على مستوى النظام، تلك التي وقعت في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، حين اتُّخذت قرارات تبدو اقتصادية بحتة، لكن نتائجها كانت ثقافية وهووية واجتماعية الطابع.
فمع صعود العولمة، شرعت كبرى الشركات الأمريكية في ترحيل وظائف التصنيع الدقيقة، والمهن الفنية، والحرف الإنتاجية إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، بدعوى تقليل التكلفة ورفع هامش الربح. وقد بُنيت هذه الاستراتيجية على معادلة اقتصادية واضحة: اليد العاملة في آسيا أرخص، والإنتاج أكثر كثافة، والعائد المالي أعلى.
غير أن التفكير المنظومي لا يتوقف عند الحساب المالي، بل يتساءل: ما الذي تغيّر في بنية النظام الأمريكي نفسه؟ كيف أعاد هذا القرار تشكيل الإنسان الأمريكي، لا العامل وحده، بل المواطن والهوية والمجتمع؟
أولًا: إعادة تشكيل النظام المهني.. من "الحرفي" إلى "المشرف"
ما حدث فعليًا هو تفكيك البنية المهنية التاريخية للمجتمع الأمريكي، الذي بُني على قيمة "إتقان الصنعة"، وتمجيد من يملك حرفة ويصنع بيده. فقد كان العامل الأمريكي – في الستينيات والسبعينيات – يجسد الكفاءة والإتقان، ويُربط اسمه بالجودة الصناعية الأمريكية، من السيارات إلى الإلكترونيات.
لكن مع ترحيل المهارات إلى الخارج، حدث تحوّل بنيوي: لم يعد الأمريكي يصنع، بل يُشرف. لم يعد يتقن، بل يراقب. فخُلِق جيل جديد من الموظفين يحملون مسميات "مدير عمليات"، "محلل إنتاج"، "منسق جودة"، دون أن يملكوا صلة حقيقية بجوهر العملية الإنتاجية.
وهكذا انتقل النظام المهني من "الإنتاج المهاري" إلى "الإشراف الرمزي"، وهو تحول لا يُقاس فقط بالأجور أو الوظائف، بل بتموضع الإنسان ذاته داخل علاقته بالعمل، وبما يمثله العمل من قيمة وهوية.
ثانيًا: فقدان الاستقلال الإنتاجي.. حين يصبح الاقتصاد هشًا رغم ضخامته
حين تواجه دولة كأمريكا أزمة في سلاسل الإمداد – كما حصل خلال جائحة كورونا – يتضح أن ما تم ترحيله لم يكن فقط وظيفة، بل قدرة سيادية. فالتفكير المنظومي يُذكّرنا بأن الأمن الإنتاجي لا يُقاس بعدد الشركات، بل بوجود المهارة داخل النسيج المحلي، وبتوازن التوزيع المعرفي داخل حدود الدولة.
ترحيل المهارات – كترحيل الكفاءات – لا يُعوض بسلاسل توريد، بل يُفقد المجتمع حقه في التعلّم الذاتي والإنتاج السيادي.
ثالثًا: الأثر الثقافي والاجتماعي: التدهور الصامت
التفكير الخطّي يرى أن ارتفاع أعداد المديرين علامة على التقدّم، لكن التفكير المنظومي يرى أن فقدان الحرفيين علامة على التآكل الداخلي. فما معنى أن يُربّى جيل على أن العمل اليدوي أقل شأنًا؟ أن يتخرج آلاف الطلبة دون أن يحمل أحدهم مهارة محسوسة، تُنتج شيئًا يُمسك باليد؟
هذا التغير لم يكن اقتصاديًا فقط، بل ثقافيًا، أعاد تشكيل معنى العمل، وقيمة الجهد، ومفهوم النجاح. وتحول العمل المنتج إلى وظيفة مؤقتة مهاجرة، والمهنة إلى مرحلة انتقالية قبل "الوظيفة المكتبية".
رابعًا: العبرة المنظومية: الرأسمالية دون رؤية منظومية تُدمر ذاتها
إن الدرس الأكبر من هذه التجربة ليس في فشل قرار أو نجاحه، بل في ضيق أفق الرؤية التي قادته. فحين تفتقر الرأسمالية للوعي المنظومي، تُسخّر كل قرار لمصلحة الربح اللحظي، دون فهم لتفاعلاته البنيوية. فينتج عنها نظام اقتصادي ضخم، لكنه هش، ومجتمع يملك وظائف عليا، لكن يفتقر إلى أساسها.
لو نظر صانع القرار حينها بمنظور منظومي، لفهم أن المهارة ليست فقط أداة إنتاج، بل أداة انتماء. وأن العامل الذي يفخر بما يصنع، يبني هوية وطنية، لا خط إنتاج فقط.
عندما تُرحَّل الوظائف وتُرحَّل معها الهوية: قراءة منظومية لقرار نقل المهارات من أمريكا إلى الصين
إن من أبرز الأمثلة العالمية التي تُجسّد الحاجة للتفكير على مستوى النظام، تلك التي وقعت في الولايات المتحدة خلال العقود الثلاثة الماضية، حين اتُّخذت قرارات تبدو اقتصادية بحتة، لكن نتائجها كانت ثقافية وهووية واجتماعية الطابع.
فمع صعود العولمة، شرعت كبرى الشركات الأمريكية في ترحيل وظائف التصنيع الدقيقة، والمهن الفنية، والحرف الإنتاجية إلى الصين ودول جنوب شرق آسيا، بدعوى تقليل التكلفة ورفع هامش الربح. وقد بُنيت هذه الاستراتيجية على معادلة اقتصادية واضحة: اليد العاملة في آسيا أرخص، والإنتاج أكثر كثافة، والعائد المالي أعلى.
غير أن التفكير المنظومي لا يتوقف عند الحساب المالي، بل يتساءل: ما الذي تغيّر في بنية النظام الأمريكي نفسه؟ كيف أعاد هذا القرار تشكيل الإنسان الأمريكي، لا العامل وحده، بل المواطن والهوية والمجتمع؟
أولًا: إعادة تشكيل النظام المهني.. من "الحرفي" إلى "المشرف"
ما حدث فعليًا هو تفكيك البنية المهنية التاريخية للمجتمع الأمريكي، الذي بُني على قيمة "إتقان الصنعة"، وتمجيد من يملك حرفة ويصنع بيده. فقد كان العامل الأمريكي – في الستينيات والسبعينيات – يجسد الكفاءة والإتقان، ويُربط اسمه بالجودة الصناعية الأمريكية، من السيارات إلى الإلكترونيات.
لكن مع ترحيل المهارات إلى الخارج، حدث تحوّل بنيوي: لم يعد الأمريكي يصنع، بل يُشرف. لم يعد يتقن، بل يراقب. فخُلِق جيل جديد من الموظفين يحملون مسميات "مدير عمليات"، "محلل إنتاج"، "منسق جودة"، دون أن يملكوا صلة حقيقية بجوهر العملية الإنتاجية.
وهكذا انتقل النظام المهني من "الإنتاج المهاري" إلى "الإشراف الرمزي"، وهو تحول لا يُقاس فقط بالأجور أو الوظائف، بل بتموضع الإنسان ذاته داخل علاقته بالعمل، وبما يمثله العمل من قيمة وهوية.
ثانيًا: فقدان الاستقلال الإنتاجي.. حين يصبح الاقتصاد هشًا رغم ضخامته
حين تواجه دولة كأمريكا أزمة في سلاسل الإمداد – كما حصل خلال جائحة كورونا – يتضح أن ما تم ترحيله لم يكن فقط وظيفة، بل قدرة سيادية. فالتفكير المنظومي يُذكّرنا بأن الأمن الإنتاجي لا يُقاس بعدد الشركات، بل بوجود المهارة داخل النسيج المحلي، وبتوازن التوزيع المعرفي داخل حدود الدولة.
ترحيل المهارات – كترحيل الكفاءات – لا يُعوض بسلاسل توريد، بل يُفقد المجتمع حقه في التعلّم الذاتي والإنتاج السيادي.
ثالثًا: الأثر الثقافي والاجتماعي: التدهور الصامت
التفكير الخطّي يرى أن ارتفاع أعداد المديرين علامة على التقدّم، لكن التفكير المنظومي يرى أن فقدان الحرفيين علامة على التآكل الداخلي. فما معنى أن يُربّى جيل على أن العمل اليدوي أقل شأنًا؟ أن يتخرج آلاف الطلبة دون أن يحمل أحدهم مهارة محسوسة، تُنتج شيئًا يُمسك باليد؟
هذا التغير لم يكن اقتصاديًا فقط، بل ثقافيًا، أعاد تشكيل معنى العمل، وقيمة الجهد، ومفهوم النجاح. وتحول العمل المنتج إلى وظيفة مؤقتة مهاجرة، والمهنة إلى مرحلة انتقالية قبل "الوظيفة المكتبية".
رابعًا: العبرة المنظومية: الرأسمالية دون رؤية منظومية تُدمر ذاتها
إن الدرس الأكبر من هذه التجربة ليس في فشل قرار أو نجاحه، بل في ضيق أفق الرؤية التي قادته. فحين تفتقر الرأسمالية للوعي المنظومي، تُسخّر كل قرار لمصلحة الربح اللحظي، دون فهم لتفاعلاته البنيوية. فينتج عنها نظام اقتصادي ضخم، لكنه هش، ومجتمع يملك وظائف عليا، لكن يفتقر إلى أساسها.
لو نظر صانع القرار حينها بمنظور منظومي، لفهم أن المهارة ليست فقط أداة إنتاج، بل أداة انتماء. وأن العامل الذي يفخر بما يصنع، يبني هوية وطنية، لا خط إنتاج فقط.
هذا المثال يوضّح بجلاء أن القرار الاستراتيجي، حين لا يُقرأ كجزء من نظام حيّ، يتسبّب في إعادة تشكيل النظام بطريقة لا يمكن التحكم فيها لاحقًا. والتفكير المنظومي، في هذا السياق، لا يكتفي بمساءلة الأثر، بل يُحاكم منطق الرؤية ذاته، ويعيد صياغة الأسئلة: لا "ما ربحنا؟" بل "ما الذي خسرناه دون أن نراه؟".